
في يوليو 2025، تحوّلت قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق إلى قضية رأي عام بعد أن انتشر مقطع مصوّر وثّق اعتداءً جسديًا تعرّضت له داخل منزلها على يد طليقها. إلا أن ما بدا كدليلٍ واضح على عنفٍ منزليّ موثّق، انقلب إلى أداة تُستخدم لتجريم الضحية نفسها، إذ
وُجّهت إلى هدير اتهامات بانتهاك الخصوصية وتم التحفظ عليها إثر ذلك.
في ضوء تلك الواقعة، نحاول تقديم قراءة تحليلية للتغطية الإعلامية وردود الفعل القانونية المرتبطة بالقضية، وذلك انطلاقًا من نهج نسوي تقاطعي. ذلك من خلال النظر في الكيفية التي أعاد بها الخطاب الإعلامي والمؤسساتي إنتاج العنف ضد هدير، من خلال نشر أخبار بعناوين غير واضحة، تُركز بشكل أساسي على تقييم الضحية، سلوكها، وتاريخها، بدلًا من التركيز على الجريمة نفسها من جهة، والانحياز للمتهم من جهة أخرى من خلال نشر أقوال محاميه دون التطرق إلى نقل الواقعة من وجهة نظر الضحية، بل والتحريض على التمييز والعنف ضد الضحية. مما يكشف عن فجوات في السياسات الإعلامية والقانونية القائمة.
يستند التحليل إلى عيّنة من التغطيات الصحفية التي واكبت القضية، ويقارنها بأنماط متكررة في التعامل مع الناجيات من العنف الأسري في مصر، حيث يُعاد استخدام أدوات القانون والإعلام كوسائل لتقييم النساء والحكم عليهنّ من جهة، وإعادة السيطرة والتأديب الاجتماعي عليهنّ من جهة أخرى. كما تقدّم الورقة استنتاجات أوّلية حول السياسات المطلوبة لضمان عدالة إعلامية وقانونية للناجيات، وتحقيق حماية فعلية لحقهنّ في الحماية من العنف الأسري، والأمان الجسدي وحريتهنّ في سرد حكايتهنّ.
تفكيك التناول الإعلامي: من التضامن إلى التشكيك
عكست التغطيات الإعلامية المختلفة لقضية هدير عبد الرازق نمطًا متكررًا من الخطاب الصحفي الذي يُساهم في إعادة إنتاج العنف ضد الضحايا، من خلال استخدام لغة غير حساسة للعنف الواقع على النساء، وتفريغ الوقائع من بُعدها الجندري، كما تتغافل من علاقات وموازين القوى غير المتكافئة بداخلها، وتُرسخ بشكل قاطع لمحاكمة الضحية، والتشكيك في روايتها وتشويهها بل وإدانتها.
ففي تقرير «الأهرام»، جاء العنوان بصيغة تهكمية: “هدير عبد الرازق.. بلوجر سقطت من تريند الاستغاثة إلى قبضة الأمن“، وهو عنوان يحوّل فعل النجاة ذاته (الاستغاثة) إلى أداة للسخرية، ويقدّم سرد هدير لروايتها وتسجيلها لهذا الاعتداء على أنه “تريند” لا كدليل، ويُقدم القبض على هدير على أنه سقوط في قبضة الأمن وكأنها كانت هاربة من العدالة ولم تكن الشرطة قادرة على العثور عليها. مما يضعنا أمام إشكالية كبيرة وهي “كيف تتعامل المؤسسات الصحفية مع بلاغات العنف الأسري” تحديدًا إذا أتت تلك البلاغات/الاستغاثات من نساء غير نموذجيات وفقًا للرؤية المجتمعية. واستُهلّ الخبر بوصفه “مشهدًا دراميًا جديدًا”، في تجريد كامل للحدث من أبعاده الواقعية كجريمة عنف منزلي، وتحويله إلى مشهد تمثيلي، مما يدفع القارئ بشكل تلقائي إلى تشكيك القارئ في رواية الضحية.
أما «أخبار اليوم»، فقد ركّزت في عنوانها على “شروط هدير المادية للتصالح“، في تسليط على البعد المالي بطريقة تنمّط النساء الناجيات كـ”مستغلات” بدلًا من تسليط الضوء على دوافعهنّ للبقاء أو الانسحاب من علاقة عنيفة. وتم تمرير رواية المعتدي في تعمد واضح لتجاهل الضحية ورسم صورة مقصودة حول كونها شخصية مادية، بل ودُمجت القضية مع قضايا قديمة تتعلق بتسريبات سابقة، ما يخلق تراكمًا مقصودًا لصورة “غير جديرة بالتعاطف مع الضحية”.
وفي تغطية «المصري اليوم» و«الشروق» جرى تصدير واقعة القبض على هدير في المقدمة، بينما وُضع فعل الاعتداء في خلفية العنوان، مما يعكس انحيازًا مؤسسيًا في تحديد ما يُعتبر “خبرًا”. وأثارت تلك التغطية لدينا تساؤلات ونحن نعمل على رصد الأخبار الخاصة بالواقعة، هل كانت الجريدتان سيكون لديهما نفس الاهتمام بهذا الخبر إن اشتمل فقط على واقعة الاعتداء على هدير، أم أن التغطية بالأساس تمت لخبر ” القبض على هدير”، وليس لخبر الاعتداء عليها؟ بالرغم من أن واقعة العنف موثّقة.
وفي مثال بالغ التضليل نشرت «صدى البلد» عنوانًا ينطوي في صياغته على مفاهيم مُسيئة ومُشيئة للنساء “النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة..”، عنوناً يحمل الوصم المسبق ويستهدف بالأساس جذب القراء لمحتوى ذا طابع جنسي، مما يدفع القارئ لتكوين صورة ذهنية تلقائية عن الضحية مليئة بالأحكام. ويعد هذا العنوان بمثابة دعوة لتغيير دفة الحقيقة والعدالة بدون أن يلجأ القارئ حتى إلى قراءة تفاصيل الخبر. هذا قبل أن يُفرد الخبر لعرض رواية محامي المعتدي بشكل مطوّل دون تحقق أو موازنة أو نشر الرواية المقابلة.
رصدنا في الفقرة السابقة جزء من التغطية الإعلامية حيث أننا ركزنا على الصحف والجرائد المصرية الرسمية أو الأكثر تداولًا، ولم نتطرق إلى جميعها الذي من المحتمل أن يكون أكثر سوءًا. هذا النوع من التغطية الإعلامية التي رصدناها لا ينقل الخبر فقط، بل يصوغ الإطار الذي يُطلب من الجمهور والقضاء أن يفهموا من خلاله القصة. عبر هذه اللغة، تتحول الناجية من موقع الضحية إلى موقع الشك والاشتباه والاتهام. وهذا لا يؤثر على وعي القراء والشارع فقط، بل يتسرّب أيضًا إلى عقل المنظومة التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، التي يعمل أعضاؤها داخل نفس الثقافة ويمرون على ذات العناوين.
إن ما تظهره هذه التغطيات ليس انحرافًا فرديًا، بل جزء من بنية أوسع تُشرعن العنف من خلال اللغة، وتحاكم النساء من خلال الصور النمطية لا الوقائع.
من التوثيق إلى الاتهام: قراءة في الانحياز القانوني ضد النساء الناجيات من العنف الأسري
تعكس الوقائع المتتالية التي تعرّضت لها هدير عبد الرازق التناقض البنيوي في تطبيق العدالة الجنائية في قضايا النساء، خاصةً من ينتمينّ إلى طبقات مهمشة أو لا يتوافقنّ مع الصورة النمطية للضحية “المقبولة” اجتماعيًا. فبالرغم من نشر هدير بنفسها مقطع فيديو يُظهر تعرّضها للضرب والسحل والسب داخل إحدى الشقق السكنية -وهو ما يعد دليلًا ماديًا على واقعة اعتداء واضحة- إلا أن الجهات الرسمية لم تتعامل معها كمجني عليها، بل جرى توقيفها هي والمعتدي على قدم المساواة. وفي ضوء ذلك، من المهم التعرّض الموقف الرسمي من قضية هدير عبد الرازق، من خلال قراءة الوقائع القانونية، والاتهامات الموجهة ضدها، ومقارنة حالتها بواقع نساء أخريات في ظروف اجتماعية شبيهة، بغرض تفكيك الكيفية التي يُوظَف بها القانون لإعادة إنتاج الهيمنة الذكورية ودائرة ممارسة العنف لا كسرها أو تفكيكها.
عقب تداول الفيديو، بالرغم من إقدام هدير على حذفه، تحركت الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بالاعتداء عليها الذي ظهر في مقطع الفيديو، وكذلك القبض على المجني عليها هدير نظير تهم وجهها إليها محامي المتهم بتصوير مقطع الفيديو بدون إذنه والتشهير به وفقًا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، حسب أقوال المحامي، واعتمد على مسيرة هدير -غير المقبولة اجتماعيًا- لإزاحة صفة “الضحية” عنها، حيث أوضح أن واقعة الضرب هذه نتاج خلاف بينهما لرفضه تعاطيها للمخدرات، وأن هذا الفيديو تم تصويره بهدف التشهير بموكله. ويتضح في هذا السياق، كيف يتم استخدام الطبقة الاجتماعية والاقتصادية لفقدان “التعاطف” القانوني والمجتمعي مع ضحية اعتداء. بالرغم من أن ما تعرّضت له هدير هو جريمة، وبدلًا من اعتبار نشر الفيديو دليلًا على وقوع الجريمة، تم الاعتداد بأن التسجيل والنشر نفسه جريمة منفصلة يُعاقب عليها القانون. وبذلك، تتحول وسائل الدفاع الذاتية والتوثيق إلى أدوات تُستخدم لإدانة الضحية لاحقًا، ذلك في مقابل ما تواجهه الناجيات من إشكاليات إلقاء عبء الإثبات عليهنّ من إحضار الشهود وغيرها، مما يعكس منظورًا تقليديًا للعدالة لا يراعي السياقات الجندرية والسلطوية للعنف -وعلى وجه التحديد- في المجال الخاص.
وعلى الرغم من حصول تصالح بين الطرفين على إثره تم إخلاء سبيل المتهم، وذلك استنادًا على أن التصالح في قضايا الضرب البسيط (المادة 242 عقوبات) سببًا لحفظ الدعوى أو تخفيف العقوبة. بيد أنه في سياق هذه الواقعة، تم التصالح في واقع غير متكافئ من حيث القوة والسلطة، فالضحية كانت بالفعل رهن احتجاز نتاج تهم تم توجيهها في المقابل من قبل المتهم -بجانب تنفيذ حكم قضائي غيابي سنتطرق له لاحقًا- مما يجعل قبولها بالتصالح أقرب للإكراه القانوني منه إلى الإرادة الحرة، وبالتالي هو بمثابة تكريس لاختلال موازين القوى بين المتهم والضحية.
نشر مقطع الفيديو وفرصة عقاب أخرى للمجني عليها
بينما تم إخلاء سبيل المتهم بعد إنهاء إجراءات التصالح، استمر حبس هدير نظير حكم قضائي صدر غيابيًا بحقها من المحكمة الاقتصادية في توجيه خمسة اتهامات إليها، تتضمن نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام، وارتكاب فعل فاضح علن، والدعوة إلى الفجور، والاعتداء على قيم الأسرة المصرية، واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم، وذلك فيما يتعلق بمحتواها على وسائل التواصل الاجتماعي. بجانب اتهامها في قضية أخرى تتعلق بحادث سير. حيث يتضح تحوّل منطق آليات القانون من أدوات للحماية إلى وسائل للرقابة والتأديب، خاصة النساء اللواتي لا تسرنّ على نمط القواعد الاجتماعية أو تشتبكنّ مع السلطة الأخلاقية وفقًا للرؤية الرسمية. كما تكشف هذه الواقعة بأنه لا تتعامل منظومة العدالة الجنائية، في أحيان عدة، مع النساء كمجني عليهنّ، بل كمذنبات محتملات، خاصةً عندما يخترنّ نشر توثيق لما يتعرّضنّ له من انتهاكات، وهو ما حدث سابقًا مع سوزي الأردنية عند نشرها لمقطع بث مباشر بينما كان والدها يحاول الاستيلاء على أموالها، فتم القبض عليها أخرى في دعوى سب لوالدها لم يُحرّكها الأب من الأساس.
قضية هدير في سياق أوسع: نمطية العقاب الاجتماعي والقانوني للناجيات
لا تمثّل واقعة هدير عبد الرازق حالة فردية أو استثنائية في التعامل مع النساء الناجيات من العنف، بل تعبّر عن نمط متكرر من العقاب الاجتماعي والقانوني، لا سيما تجاه من لا ينطبق عليهنّ قالب “الضحية المقبولة” اجتماعيًا. ففي ظل مجتمع تتعرض فيه النساء يوميًا لانتهاكات في المجالين العام والخاص، تصبح اللغة الإعلامية نفسها أداة عنف، تعيد إنتاج السيطرة على أجساد النساء وتجاربهنّ.
في الصحافة المصرية، كثيرًا ما يُعاد تأطير الجرائم الواقعة على النساء باعتبارها “خلافات أسرية” أو “مشاحنات عاطفية”، بينما يُعاد تأطير جرائم القتل باعتبارها “ناتجة عن الغيرة أو الحب – أو دفاعاً عن ما يُسمى بالشرف”، ما يُفرغ الجريمة من طابعها القانوني ويعيد تحميل الضحية جزءًا كبيراً من المسؤولية.
يُظهر مثال التغطية الإعلامية لحادثة تعدّي الفنان أحمد السقا على طليقته الإعلامية مها الصغير هذا المنطق بوضوح. نشرت صحيفة «الدستور» تقريرًا بعنوان: “ضرب وسب وإهانة.. كواليس خناقة الكمبوند بين مها الصغير وأحمد السقا“، وهو عنوان يدمج فعل الاعتداء الجسدي في كلمة “خناقة”، بما يموّه الجريمة ويحولها إلى خلاف متكافئ. كما اختتم التقرير بذكر منشور السقا عن الطلاق، في تسلسل يُعيد ترتيب السرد لصالحه، ويمحو الأثر القانوني للاعتداء. وبعد انتهاء الاهتمام بهذه الواقعة، أعيد تداول خبر عن انتحال مها الصغير لرسومات، ما ساهم في ترسيخ صورتها كمذنبة، مقابل محو صورة السقا كمعتدٍ.
وبشكل موازٍ، تكشف قضايا مثل قضية منة عبد العزيز عن منطق عقابي ممنهج تجاه النساء اللواتي يبلّغنّ عن الاعتداء. في عام 2020، نشرت منة مقطع فيديو استغاثة بعد تعرّضها لاعتداء جنسي وجسدي، لكنها قوبلت بالحبس بناء على اتهامات مثل التحريض على الفسق وتزوير حساب إلكتروني. وعلى الرغم من نقلها لاحقًا إلى مركز لحماية النساء المعنّفات بعد مطالبات واسعة، لم يأتِ ذلك كاعتراف بكونها ناجية، بل كامتداد لمنطق التأديب المؤسسي المغلف بخطاب الحماية.
الأمر ذاته تكرر في حالة سوزي الأردنية، التي وثّقت عبر بث مباشر محاولة والدها الاستيلاء على أموالها. بدلًا من مساءلة الطرف المعتدي، جرى القبض عليها لاحقًا في دعوى “سبّ وقذف”، رغم عدم وجود بلاغ مباشر من الأب. في كل هذه النماذج، يتضح كيف تُستدعى مفاهيم فضفاضة مثل “قيم الأسرة” أو “الحياء العام” لتأديب النساء، لا لحمايتهنّ.
تشترك وقائع تلك النساء في خيط واضح: النساء اللواتي يخرجنّ عن السياق الأخلاقي المقبول مجتمعياً – بالتصوير، بالاستغاثة، أو بمجرد التعبير – يُعاملنّ كمذنبات، لا كناجيات. حيث تُرسخ العادات المجتمعية لما يُسمى بـ”الأصول المجتمعية” التي تخلق صورة نمطية حول تواجد النساء والفتيات في المجال الخاص، كشخصيات ليست لديها صوت، وليس لديها الحق في التعبير عن كونها تتعرض للظلم، التمييز أو\و العنف إلا من خلال الصبر والصمت والدعاء، بل وتلك الصورة للنساء الصامتات هي صورة النساء المثاليات. تسهم التقاطعات في الوقائع السابقة بين الطبقة الاجتماعية، والتمثيل الإعلامي، والسلطة الأخلاقية في تحويل القانون من أداة حماية إلى أداة تأديب.
دلالات الخطاب العام حول العنف الأسري
يُظهر الخطاب الإعلامي السائد في تغطيته لقضايا العنف الأسري ضد النساء انحيازًا بنيويًا يتجاوز مجرد نقل الحدث إلى المشاركة في إعادة تأطيره وتطبيعه. ففي الغالب، لا يُوصَف فعل الاعتداء الجسدي كـ”جريمة”، بل يتم تخفيفه لغويًا من خلال عبارات مثل: “خلافات زوجية”، أو “تعدّى الزوج على زوجته بسبب مشادة كلامية.”
هذا التخفيف لا يعكس فقط افتقار التغطية إلى حساسية جندرية، بل يعكس ثقافة مجتمعية تُمجّد عنف الرجل على المرأة وتُحمّل الضحية اللوم. تنبع هذه الثقافة من موروث شعبي راسخ، تعبّر عنه أمثال دارجة مثل: “ضرب الحبيب زي أكل الزبيب”، و”اكسر للمرأة ضلع يطلع لها 24″، و”علقة تفوت ولا حد يموت”، وغيرها. كما تلعب الدراما المصرية دورًا محوريًا في تكرار هذا النمط من العنف وتبريره، إلى جانب خطاب ديني تقليدي يُجيز ضرب الزوجة في بعض السياقات ويُعزّز خضوع النساء كفضيلة.
في هذا السياق، يصبح غياب التغطية الإعلامية المراعية للنوع الاجتماعي، أحد أبرز أسباب استمرار تطبيع العنف ضد النساء. فالإعلام لا يكتفي بتبرئة المعتدي ضمنيًا، بل يُشارك في صياغة بيئة رمزية تعزّز قبول العنف كممارسة مشروعة ومفهومة اجتماعيًا. وتزداد خطورة هذا الواقع في ظل وجود قوانين لا تُجرّم كافة أشكال العنف، بل وتخضع أحيانًا لمرجعيات دينية تتقاطع مع النظام الأبوي. ومع غياب الوعي المجتمعي، وعدم كفاية البنية القانونية، تصبح نساء مثل هدير عبد الرازق، ومها الصغير، وكثيرات غيرهنّ، بلا حماية حقيقية، ويواجهنّ العنف الأبوي بشكل يومي، في مناخ قانوني ومجتمعي لا يضمن لهنّ لا الأمان ولا العدالة.
خاتمة واستنتاجات:
تكشف قضية هدير عبد الرازق عن فجوة بنيوية متكرّرة في تعامل المؤسسات القانونية والإعلامية مع النساء الناجيات من العنف، خصوصًا حين يسعين لتوثيق الاعتداء أو كشفه. فعوضًا عن أن تتحول أداة التوثيق إلى وسيلة حماية ومساءلة، تُستخدم ضد الناجية في إطار قانوني واجتماعي يُعيد إنتاج السيطرة عليها ومعاقبتها. كما يُظهر تحليل التغطية الإعلامية عجزًا منهجيًا في الصحافة المصرية عن تبنّي مقاربات حسّاسة للنوع الاجتماعي، إذ تميل كثير من التغطيات إلى تطبيع العنف، وتبرير سلوك المعتدي، وتحويل الناجية إلى موضوع للتشكيك أو السخرية أو التهوين من معاناتها.
تعكس هذه الأنماط حاجة ملحّة إلى مراجعة السياسات الإعلامية والتشريعية القائمة، والتفكير في آليات تكفل ألا تُستخدم أدوات العدالة كوسيلة لإسكات النساء. كما تؤكد الورقة أن معالجة مثل هذه القضايا لا تقتصر على تغيير خطاب أو مادة قانونية، بل تتطلب تحولًا أعمق في التصورات المجتمعية حول العنف، والخصوصية، وحق النساء في النجاة والرواية.


 Previous Post
Previous Post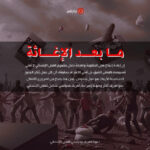 Next Post
Next Post